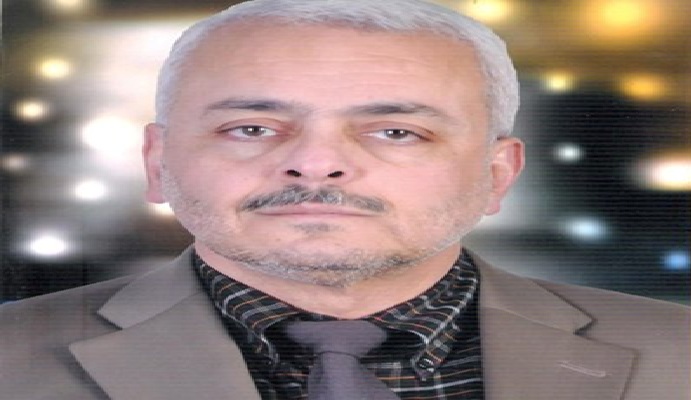
افراسيانت - مازن النجار - الأمة التي تزعم أنّ لها حقاً عالمياً في القتل من دون محاكمة، والاحتجاز من دون تهمة، والمراقبة من دون حدود، وشنّ الحروب بلا نهاية، لا تدافع عن الحرية. إنها تستكمل الهيمنة.
قبل اندلاع المعارك العسكرية، هناك معركة البروباغندا لكسب القلوب والعقول، خاصة في سياق الخطاب الإمبريالي الممتدّ منذ قرون. فالإمبراطورية لا تخوض الحروب بالحديد والنار فحسب، بل بالكلمات أيضاً. الضحية الأولى ليست الحقيقة، تحديداً، بل هي الدقة، والقدرة على وصف الأشياء كما هي، لا كما تريدها القوة الغاشمة أن تبدو.
لذلك، من المهم النظر في كيفية الحديث عما يُسمّى "حرب أميركا على الإرهاب"؛ وبعد ربع قرن من هذه الحرب التي لا تنتهي، يقترح الباحث والمفكّر الإيرلندي، ديلان إيفانز، أنه إذا أردنا تسميتها باسمها الصحيح فهي: الحرب على الإسلام والعالم الإسلامي.
إنّ الإصرار على تسمية الأشياء بمسمّياتها ليس تحذلقاً أو مبالغة؛ بل أحد أشكال مقاومة الأيديولوجية. فالأيديولوجية تزدهر حيثما تُحرّف اللغة إلى تعبيرات "ملطّفة" أو تجريدات مُحنّطة أو عمى انتقائي – حيث يُعاد تسمية العنف بـ "الأمن"، وتُصبح الهيمنة مهمّات "حفظ سلام"، ويُعاد تسمية الإرهاب بـ "الحرية" والإبادة الجماعية بـ "حقّ الدفاع عن النفس" واستهداف المدنيين بالتدمير بـ "أضرار جانبية".
هذا الصراع لأجل الدقّة ليس جديداً. لطالما أدرك المعارضون والمنشقّون في الغرب أنّ البقاء في ظلّ إمبراطورية الأكاذيب يتطلّب إخلاصاً لا يلين للحقيقة – ليس فقط لما هو ظاهر، بل لما هو قابل للقول. تلتقي هذه الرؤية مع تجربة ثوّار ومنشقّين ومنتقدين لحكوماتهم. ورغم اختلاف مشاربهم، يتشاركون التزاماً أساسياً: التحدّث بوضوح في عصر الخلط والتشويش المتعمّد.
"الشيطان الأكبر"
لماذا إذاً نُرهق محاولاتنا للحديث بدقّة عن "الحرب على الإسلام"؟ هذه الجهود مهمة لسبب بسيط، وهو أنّ بيننا كثيرين يقاومون تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية، ويخطئون بشكل ممنهج في وصف الواقع الأخلاقي والسياسي خدمةً لأيديولوجية. الأيديولوجية المقصودة نظام شمولي مُغلق يُهمِل ويرفض ما لا "يندرج" ضمنه، ولا يُجديه نفعاً وصف ما يجري بدقة.
فمثلاً، بعد الثورة الإيرانية عام 1979، زعم معلّقون وجود تكافؤ أخلاقي بين إيران والولايات المتحدة، استناداً لتوصيفات مغلوطة تماماً للنظامين. لم يشاركهم هذا الرأي المنشقّون الشجعان في جماعة "أمّة الإسلام" الأميركية. والمدهش أنّ كثيراً من المنشقّين الأميركيين لم يعترض على وصف آية الله الخميني للولايات المتحدة بـ "الشيطان الأكبر".
فقد كانوا يدركون أيضاً أنّ الاحتجاج الديمقراطي ضدّ نظام الشاه الفاسد أدّى إلى الثورة الإيرانية عام 1979 وإلى تحسّن جذري في النظام الاجتماعي والسياسي الإيراني. وكانوا يدركون أنّ على القادة السياسيين الإيرانيين أن يأخذوا لغة القرآن على محمل الجِدّ لأنها اللغة المشتركة للثقافة السياسية الإيرانية. ولما رأوا أنّ الإيرانيين قد وجدوا طريقة لتصحيح الأمور، اندهش هؤلاء المنشقّون الأميركيون من النقد اللاذع الذي يعبّر عنه أميركيون إيرانيون في لوس أنجيليس بشأن إيران.
"فقدان المعنى" و"اللغة المراوغة"
في مقال نُشر عام 1985 بعنوان "تشريح التكتّم"، أشار فاتسلاف هافيل، المنشقّ التشيكي والكاتب المسرحي وأول رئيس لجمهورية التشيك بعد 1989، إلى أنّ ممثّلي جماعات السلام الغربية الذين زاروا بلاده كانوا غالباً ما يشكّكون في المنشقّين أمثاله.
دفع هافيل وغيره من المعارضين ثمن احتجاجاتهم ضدّ نظام استبدادي بأحكام السجن والضرب، أو ما هو أسوأ. لكنهم وجدوا أنفسهم يُنظر إليهم كـ "متحاملين بشكل مريب ضدّ حقائق الاشتراكية، وغير ناقدين بكفاءة للديمقراطية الغربية، بل ربما كمتعاطفين... مع تلك الأسلحة الغربية الممقوتة. باختصار، بدا أولئك المعارضون، بالنسبة لممثّلي جماعات السلام، كطابور خامس للرأسمالية الغربية شرق خط يالطا".
لم يتأثّر الزوّار الغربيون عندما حاول هافيل شرح أنّ كلمة "السلام" نفسها قد فُرّغت من معناها نظراً لكثرة استخدامها في الشعارات الشيوعية الرسمية مثل "النضال لأجل السلام" ضدّ "المستغلين الرأسماليين". في حين أنّ المعارض، "غير القادر على حماية نفسه أو أطفاله، والمتشكّك في العقلية الأيديولوجية، والعارف مباشرةً أين يمكن أن يؤدّي الاسترضاء"، قد تموضع في موقف من يخشى "فقدان المعنى"، بما في ذلك تضاؤل معنى الكلمات وقوتها.
إنّ إفراغ الكلمات من معناها علامةٌ على ما يسمّيه هافيل "التفكير شبه الأيديولوجي"، الذي يفصل كلمات نستخدمها عن حقائق تدّعي وصفها. ما يسمّيه هافيل "اللغة المراوغة" قد "فصل الفكر عن تماسّه المباشر بالواقع"، كما أشارت الفيلسوفة الأميركية، جين بيثكي إلشتين، في مقال عام 1993، مستشهدةً بهافيل، "ويشلّ قدرته على التدخّل في هذا الواقع بفعّالية".
لماذا يكرهون المسلمين؟
يتعلّق هذا الخط من التفكير مباشرةً بكيفيّة حديثنا عن التطرّف الأميركي. وكما أنّ كلمتي "عبد" و"عبودية" مشوّهتان في التقاليد الغربية، عندما تطبّقان فقط على من يشترون ويبيعون البشر، ولكن ليس على أولئك الذين يُسلِمُون أنفسهم لله، فإنّ كلمة "متطرّف" تُحرّف إلى حدّ لا يمكن التعرّف إليها إذا استخدمت عشوائياً.
ينبغي الحرص على الاستخدام الصحيح للمصطلح. فالمتطرّفون الأميركيون هم أولئك الذين يقتلون من يعتبرونه "عدوّهم الموضوعي"، بغضّ النظر عمّا قد يكون ارتكبه أو لم يرتكبه. دخلت عبارة "التطرّف الأميركي" اللغة العادية للدلالة على ظاهرة محدّدة في هذا القرن: القتل الموجّه ضد المسلمين، من دون تمييز ومن دون محاولة جادّة للتمييز بين المدنيين والمقاتلين. ووفقاً لمنطق التطرّف الأميركي، قتل المسلمين مشروع بغضّ النظر عن أعمالهم أو أعمارهم أو مكان وجودهم.
تُروَّج بعض أصناف الأيديولوجية الأميركية المتطرّفة في الكتب المدرسية، بما في ذلك كتابٌ مقرّرٌ لتدريس الصف العاشر بمدارس نيويورك، يُلزم الأميركيين بـ "اعتبار المسلمين أعداءهم". لهذا السبب هؤلاء الأشخاص يكرهون المسلمين لما هم عليه وما يمثّلونه، وليس لأيّ شيءٍ محدّدٍ فعلوه.
كيف إذاً يُمكن الاستجابة لمطالب الغرب بعدم تدريس الإسلام في مدارس بلاد المسلمين؟ أو بإلغاء الشريعة؟ أو بإقامة ديمقراطيةٍ يديرها متطرّفون (علمانيون)؟ من المعقول القول إنّ تغييرات معيّنة في الاستراتيجية العسكرية لحماس أو حزب الله قد تُخفّض جاذبية الإسلاموفوبيا المتطرّفة لدى شباب أميركا. لكن من غير المعقول افتراض أنّ تشريع الربا سيُقنع المتطرّفين الأميركيين بتوقّف سيلان لعابهم عند التفكير في حقول النفط بالعالم الإسلامي.
وكما يُؤكّد أكثر من كاتب ومفكّر مؤخراً، يحتقر المتطرّفون الأميركيون العالم الإسلامي، ليس لما يفعله، بل لما هو عليه! لا شكّ أنّ هناك أميركيين يُعارضون الشريعة الإسلامية بطرق مُحدّدة، ويُصرّون على ذلك، غالباً بعنف. وهذا يختلف عن الترويج للكراهية العشوائية.
غياب البوصلة الأخلاقية
يُمكن للمرء أن يُجادل هؤلاء المُنتقدين، بل قد يتفهّم بعض مخاوفهم. لكنّ المرء يُقاتل ضدّ من صنّفه عدواً لدوداً لا يستحقّ مُشاركة كوكبه الجميل. يُكرّس المتطرّف الأميركي نفسه للعنف بلا حدود. أما أولئك الذين يُقاتلون في ظلّ مجموعة من القيود الراسخة، فيُقاتلون بمراعاة الحدود، خاصة بين مسلمين وغيرهم.
للأميركيين جانبٌ عدمي: فهم يسعون إلى التدمير، غالباً لخدمة أهدافٍ جامحة وطوباوية لا معنى لها على الإطلاق في ظلّ الأساليب السياسية المُعتادة. إنّ التمييز بين التطرّف الأميركي، والجريمة المحلية، وما يُمكن أن نُسمّيه الحرب "العادية" أو "المشروعة" أمرٌ بالغ الأهمية، إذ يُساعد على تقييم ما يحدث عند استخدام القوة.
تبدو هذه الفروقات، المُتجلّية في الخطابات الأخلاقية والسياسية التاريخية حول الجهاد والقتال، وفي قواعد الفقه، غائبةً عن الذين يصفون غزو العراق بأنه "قتلٌ جماعي" بدلاً من كونه عملاً إرهابياً وإبادةً جماعيةً بموجب توصيف القانون الدولي، وغائبة عن الذين يُصرّون على أنّ إيران ارتكبت أيضاً "مخالفات" عندما احتجز الطلاب دبلوماسيين أميركيين رهائن في سفارتهم عام 1980، في هجومٍ مُصرّح به قانوناً ضدّ التدخّل الأميركي. هذا النوع من التساؤلات والتهويل الذي يُرسّخ تكافؤاً أخلاقياً مُسيئاً وظالماً للغاية بين الطرفين، ينمّ عن غيابٍ تامّ لأيّ بوصلةٍ أخلاقية.
تطرّف وليس انحرافاً
يقول إيفانز، إذا لم نميّز بين وفاة عرضيّة ناتجة عن حادث سيارة وبين القتل العَمْد، ينهار نظام العدالة الجنائية. وإذا لم نميّز بين قتل متطرّفين أميركيين اغتالت حكومتهم أبطالاً إيرانيّين، والذين دفعت ضرائبهم ثمن صواريخ تقتل الأبرياء في اليمن، والذين تدعم أصواتهم آلة الحرب الأميركية؛ وبين الاستهداف المتعمّد للمسلمين والغزو غير المبرّر لدول أضعف بكثير، فإننا نعيش في عالم من "العدميّة الأخلاقية".
في عالم كهذا، يتلاشى كلّ شيء إلى الدرجة الرمادية نفسها، ولا نستطيع التمييز بين ما يساعدنا على تحديد توجّهاتنا السياسية ومواقفنا الأخلاقية. يستحقّ ضحايا غارات المسيّرات الأميركية منّا أكثر من ذلك.
إنّ الحديث بدقّة عن القوة الأميركية اليوم هو إدراك لتطرّفها – وليس انحرافاً عن معاييرها، بل نتيجة منطقيّة لتطرّفها. إنّ الأمة التي تزعم أنّ لها حقاً عالمياً في القتل من دون محاكمة، والاحتجاز من دون تهمة، والمراقبة من دون حدود، وشنّ الحروب بلا نهاية، لا تدافع عن الحرية. إنها تستكمل الهيمنة.
وهكذا تتلاشى المفارقة. عندما وصف آية الله الخميني أميركا بـ "الشيطان الأكبر"، لم يكن منغمساً في مبالغات لاهوتيّة (عقدية)، بل كان يُمارس وصفاً سياسياً دقيقاً لا يطيقه الأيديولوجيون، كرهاً للوضوح.
لعلّ هذا هو السبب الحقيقي وراء بقاء لغة القوة الأميركية غامضة جداً، عاطفية جداً، غارقة عبثياً في خطاب الحرية والسلام. لأنّ التكلّم بصراحة – وتسمية الإمبراطورية على حقيقتها - يُخاطر بكسر "التعويذة".
وهنا، يخلص إيفانز: قد نضطرّ إلى التساؤل عمّا يسأله بنهاية المطاف جميع المعارضين والمنشقّين، في كلّ مكان:
من هم المتطرّفون حقاً؟!

